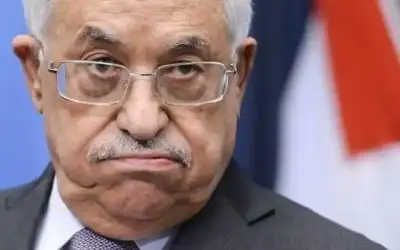هل أصبح الانقلاب معاديا للاستقرار؟
محمد الجوادي
كاتب مصري
نيسان ـ نشر في 2015-07-27 الساعة 11:40
لا يختلف اثنان على أن الاستقرار هو الهدف الأكثر إلحاحا والأكثر جدوى لأي فعل انقلابي، وأن الانقلابات مستعدة لدفع ثمن الاستقرار بأية وسيلة ومهما كان الثمن، نقدا أو إزهاقا للأرواح والممتلكات الخاصة، أو -حتى- تنازلا عن السيادة الوطنية، أي عن بعض أرض الوطن نفسه.
فالانقلاب بلا استقرار حقيقي وواقعي يقود نفسه وخطواته للتحول المرتد بسرعة إلى جوهر الأصل في طبيعته، وهو أنه فعل مستنكر قانونا وشرعا وسياسة، بل إن المتعارف عليه في تجليات الميكافيلية على مر عصورها أن الانقلاب على مدى عمره يظل تحت الاختبار، فإذا لم ينجح فإنه سوف يعاقب كفعل مؤثم مستحق العقاب، ولكنه إذا نجح تجاوز عنق الزجاجة.
ومهما قدمت السياسة الدولية من مجاملات مفرطة أو محسوبة للانقلاب، فإنها لا تعترف له بالوجود الحقيقي إلا إذا استقر على أرض الواقع، كما أن السياسة العملية متمثلة في المؤسسات الاقتصادية عابرة الجنسيات -على سبيل المثال- لا تبني سياساتها ولا تخطط استثماراتها على أساس أن الاستيلاء على السلطة أو المكاتب أو المباني يعطي الانقلاب شرعيته، وإنما تنظر إلى هذا الاستيلاء على أنه خطوة مادية مهمة أو أولية فحسب، لكنها في نظرها لا تؤمن للانقلاب مشروعية حقيقية.
وينطبق هذا الفهم أيضا على مجموعة الخطوات التالية التي تلجأ إليها الانقلابات سراعا من اصطناع انتخابات صورية، أو وضع دستور شكلي، أو تأسيس مؤسسات سياسية جديدة تصدر من الصخب أو الجدل ما يملأ الفراغ السياسي.
لكن هذه الخطوات أيضا تبقى أقل من أن تؤمن للانقلابات شرعية أصيلة أو مشروعية حقيقية حتى لو من قبيل شرعية التغلب على نحو ما عرفتها القرون القديمة أو الوسطي، وإنما يتحقق للانقلاب وجوده المستقل عن الفعل المؤثم إذا استطاع الوصول إلى الاستقرار المهيئ لاستمرار الحياة وتقدمها آمنة على نحو أو آخر.
وبعيدا عن المصطلحات السياسية أو الاجتماعية المعقدة، فإنه يمكننا استعارة الصور من حياتنا المعاصرة، والقول إن استقرار الانقلاب أو النظام السياسي على وجه العموم هو استقرار دينامي وليس استاتي، وهو ما أشبهه دائما باستقرار الطائرة في المجال الجوي، فهو استقرار ناشئ عن توازن حركي معقد يبقي جسم الطائرة وما يحمله في وضع الطيران والحركة الآمنة، ولا يمكن أن يستعاض عنه باستقرار السكون أو التوقف، إذ إن الطائرة لو توقفت وهي في الجو لسقطت من فورها محترقة بمن فيها.
وفي مقابل هذا، فإن الاستقرار القديم أو الاستاتيكي لم يعد له محل من الوجود في العصر الذي نعيشه مهما تصور المثقفون والقراء الرجعيون أن هذا ممكن وأنه ضروري.
وفي الواقع، فإن هؤلاء معذورون لأنهم يمارسون العمل السياسي من باب الحنين إلى تجربة أعجبوا بها في صباهم، الفسيولوجي أو الفكري، وهو منهج لا يصلح للسياسة حتى وإن نجح في الفن حين يتغنى الواحد منا بلحن قديم نشأ على الإعجاب به أو حين يتقمص الواحد من الساسة أداء ممثل مشهور لدور كلاسيكي بكل المقومات المثيرة للإعجاب في ذلك الأداء.
وفي مقابل هذا، فإن ممارسة السياسة لا تعترف بمثل هذا الأسلوب، ولا تضمن، بل ولا تتيح له النجاح حتى وإن بدت السياسة وهي ترحب ترحيبا تقليديا بمثل هذه القولبة مع إدراكها أنها تستحق الفشل المؤكد عند التقييم الحقيقي بل منذ التقييم المبكر.
وبعيدا عن التنظير مرة أخرى، فإن الانقلاب العسكري المصري وجد نفسه منذ الأسابيع الأولى متعرضا وبكثافة لتدفقات استفهامية كثيرة عن جوهر سياسته في المعالجات الاقتصادية ولا نقول الإصلاح الاقتصادي، فلما أثبتت الإجابات المبكرة التي قدمها قائد الانقلاب فشلها في مقاربة أسلوب محدد لتحريك أو تعزيز مقومات الاستقرار، فضل الانقلابيون الكبار أن يسحبوا الطائرة بعيدا إلى ورش الصيانة لا من قبيل إعادة تأهيلها، ولكن من قبيل النأي بها عن التعرض للسقوط الحتمي إذا ما فكرت حتى في الطيران التجريبي.
ومع هذا، فإن الأسئلة زادت وانفجرت بدلا من أن تهدأ أو تجد الإجابة الواضحة، وهكذا فإنه سرعان ما نشأت الحاجة الماسة إلى اللجوء السريع إلى سياسة زرع الطمأنينة بدلا من العمل الجاد من أجل الإنجاز، كما نشأت بفعل مخابراتي مستورد سياسة الترهيب من الإظلام التام لتكون بديلة عن سياسة الحث على البحث عن بدائل لتمويل الطموح المشروع والموعود به من قبل.
وفي مثل هذا المناخ الذي تضطرب فيه الأدوار المنوطة بالتنفيذيين الكبار، فإن رجال البنوك سرعان ما يتحولون إلى أمناء خزائن بدلا من أن يكونوا مستشاري تمويل، وكذلك يتحول رجال الرقابة على النقد إلى مفتشين بدلا من أن يكونوا موجهين، كما يتحول رجال التخطيط إلى ممارسة التبرير والمراجعة بدلا من التفكير والاقتراح.
وعلى مستوى المواطن العادي الذي هو لبّ الموضوع في السياسة سرعان ما تبرز المعاناة الحادة مع ارتفاع الأسعار، ولا يمكن عندئذ تبرئة الحكومة من المسؤولية عن هذا الارتفاع بعد أن قامت بإجراءات من قبيل رفع أسعار الوقود والنقل فضلا عن الرسوم والضرائب، ومن المفهوم أن الجماهير قد تستوعب مثل هذه المعاناة -وإن على مضض- إلا إذا وجدت ما يدفعها دفعا إلى عدم القبول بما تنتجه هذه السياسات. وفي حالتنا المصرية على وجه التحديد، فقد اضطر الانقلابيون أنفسهم بأنفسهم إلى خطوات كفيلة بزعزعة الأمل في أي استقرار مأمول.
وتمثلت أولى هذه الخطوات في لجوء الدولة الانقلابية إلى مكافأة من تظن أنهم يشكلون اللوبي الخاص بها أو أهل الثقة الخاصين بها، فإذا بالحكومة ترفع مرة بعد أخرى أجور ومعاشات القضاة والعسكريين العاملين والمتقاعدين، بينما هي في الوقت ذاته تخفض وتمنع الزيادات المشروعة في أجور المعلمين والأطباء.
وفي حين بشر الانقلاب بأنه سيعتمد على سلطاته الحاسمة (وهو الوصف المهذب للقمعية) في فرض قانون الحد الأقصى للأجور، فقد سخر القضاء نفسه من القانون إلى درجة غير متوقعة، حتى إن المحكمة الدستورية قالت ما معناه إنها لا تخضع أصلا للقانون، وقل مثل هذا في ما حصل عليه الطيارون ورجال البنوك بلي الذراع في خطوات معلنة، بل ومتحدية للاستقرار الذي يتطلب العمل على تأكيد وجود النسيج الواحد لا الأنسجة المتمايزة التي تجاهر بالعصيان إذا لم تحصل على ما تريد.
وهكذا بدأت سياسات توزيع الدخل وممارساتها تسرع بالمجتمع المصري في ظل الانقلاب إلى ما يسمى في أدبيات علوم الاجتماع سياسات أو آليات الاستقطاب المؤذنة بسقوط متسارع لسلطة الدولة مهما لجأت إلى القمع.
أما ثانية الخطوات التي شكلت للمجتمع الانقلابي صورته المستقطبة أو الاستقطابية اقتصاديا (وبالتالي غير المستقرة اجتماعيا وسياسيا) فتعلقت بالسلوك الحكومي السلبي تجاه أرقام الموازنة التي فاقمت من وضع كل الأرقام الإنذارية المعروفة سلفا، وإذا بالعجز في الموازنة الذي طنطن قائد الانقلاب نفسه -منذ عام- بأنه تصدى للحديث عن وجوب خفضه يزداد عما كان مرصودا قبل زجر القائد ونهره رئيس وزرائه.
وقل مثل هذا في كل المؤشرات الأخرى التي تجمعت وتراكمت لتكرس حقيقة مرة، وهي أن الدين الداخلي وحده تعدى 80% من إجمالي الناتج القومي، ومن ثم فقد أصبح مستقبل الإصلاح الاقتصادي نفسه في خبر كان بعد أن حفرت سياسات الانقلاب أخاديد عديدة في وجه مصر الاقتصادي، وبعد أن عادت -على سبيل المثال- إلى سياسات مراهقة كانت قد توقفت عنها منذ أكثر من أربعين عاما (وللإنصاف فقد توقفت الناصرية نفسها عنها بعد أن أنضجت هزيمة ١٩٦٧، عبد الناصر نفسه كف عن تجديد اللجوء إلى المصادرة والمنع من التصرف والاستيلاء والتأميم والحراسة).
ومن المؤكد أن مصر ستحتاج سنوات طوالا لتصحيح هذا الوضع الذي اندفع إليه الانقلاب بفعل المراهقة الفكرية لمؤيديه من ممارسي إعلام التحريض الذي لا يقود في العادة إلا إلى الخراب الاقتصادي المتسارع.
وأما ثالثة الخطوات التي يكرس بها الانقلاب -دون أن يدري- عدم الاستقرار (من باب الظن أنها علاج لأمراضه بينما هي سم بطيء قاتل لأعضائه وأنسجته) فتتمثل في طبيعة السياسة الرعناء التي رسمها أعداء جدد للإسلام وسلموا «كاتالوجها» للانقلاب لتنفيذه.
وبدلا من أن يكون الانقلاب حصيفا في تنفيذ السياسات (التي وعد عن صدق بأنها ستتم تغطيتها تماما دوليا وغربيا) فإنه (أي الانقلاب) آثر أن يصور نفسه على أنه موظف دولي معتبر ومسنود، بدلا من أن يصور نفسه ذا فكر جديد يتقاطع النفع فيه مع الخارج.
ولا نستطيع بصراحة أن نقول إن الانقلاب أخطأ في تصوير نفسه موظفا عند القوى الخارجية الأميركية أو الإسرائيلية، فقد أثبتت الأيام أن هذا التصوير الصريح رغم بشاعته وسوداويته هو الذي ضمن للانقلاب انصياع كثير من الليبراليين واليساريين والانتهازيين، وضمن للانقلاب سير هؤلاء غير المشروط وراءه في صمت وتواطؤ، حبا في الرهان المضمون.
وبدلا من أن يزعم الانقلاب أنه يمارس اشتراكية عربية مختلفة تماما ومتميزة عن الماركسية العالمية، فإنه جاهر بأنه ينفذ سياسات لها اليد العليا في عالم اليوم، وبدلا من أن يحاول إثبات تفوق عسكري أو فكري فقد حرص على إثبات علاقة عضوية متميزة حتى بعدو تقليدي.
وهكذا قاد الانقلاب نفسه إلى صراع ظاهر أو مستتر، وإلى نزاع حال أو مؤجل مع كل من يخالفه في هذا التوجه الذي لا يمكن للجماهير -أية جماهير- أن تقبل به لا على المدى القصير أو الطويل حتى وإن تظاهرت مؤقتا بأنها تصفق مع النغمة السائدة