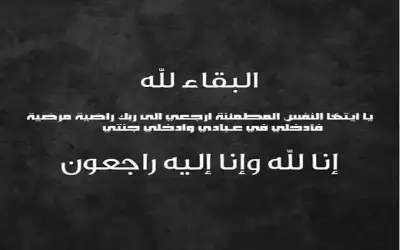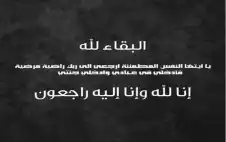حسن أبوعلي وزير ثقافة الظل الأردني
نيسان ـ نشر في 2018-08-09 الساعة 18:58
محمد قبيلات
لم تكن الزيارة التي قام بها قبل أيام رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لوسط البلد ولقاؤه بأبو علي بائع الكتب الأكثر شهرة في الأردن أول اهتمام رسمي من الدولة بهذا الرجل.
فقد كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أنعم عليه بوسام الاستقلال من الدرجة الرابعة. علق حينها أبوعلي بأن هذا الوسام “مفخرة لمن يحملون هاجس الثقافة العربية ونشرها ليس في الأردن وحسب وإنما في العالم العربي أيضا”.
وكان الملك قد كرّم أبوعلي للمرة الثانية بعد أن حصل في العام 2002 وبمناسبة الاحتفال بعمان عاصمة للثقافة العربية على ميدالية فضية من الدرجة الثانية، قال عنها آنذاك “إنه أسعد يوم في حياتي ولم أتوقع أن يحدث هذا لي في يوم من الأيام بصفتي صاحب كشك كتب صغير ومنزو في وسط البلد”.
وسبق للملكة رانيا أن زارت أبوعلي واشترت منه الكتب، حينها كتبت الصحافة أن الملكة زارت وزير الثقافة الشعبية، وصافحته وسألته عن أحوال الناس وعن إقبال أهالي عمان على شراء الكتب والصحف.
حينها اشترت الملكة ثلاثة كتب من أبوعلي، من بينها رواية للروائي زياد قاسم وأخرى لمنيف الرزاز.
ذاكرة الأردن
واليوم، لا يزال صاحب أشهر كشك لبيع الكتب صامدا في وسط العاصمة عمّان، يمارس غواياته للقراء طامعا بتجسير علاقتهم وتوطيدها بالكتاب، تراه متأهبا إلى جانب كشك الثقافة العربية، حانوت الورق العمّاني القديم، يتفحص الوجوه، يقرأ أعين المارة في شارع الملك فيصل، كأنه يعرفهم جميعا، أو هي الألفة التي دعمها حب الناس له، فكل المارة من هنا يعرفونه، وقد بقي على هذه الحال منذ عام 1955 عندما بدأ رحلته مع عوالم الورق ببيع الجرائد والمجلات، في هذا الركن غير القصي من شارع الملك فيصل، المنطلق من صحن البلد باتّجاه عمّان الجديدة المتمددة إلى الجبال الغربية.
يقول لـ“العرب” الرجل الذي أصبح ذاكرة حيّة للمكان “هنا مقابل البنك العربي كانت بناية البنك العثماني الذي أُغلق في نهاية الستينات، وإلى جانبه من جهة المسجد الحسيني، في البناية التي يحتلها الآن مركز أمن العاصمة كان مقهى العاصمة، وكانت تعتلي المبنى شاشة سينمائية كبيرة مطلة على الشارع تبث الأفلام في الهواء الطلق، يشاهدها المارة بالمجان، فلا تذاكر ولا مقاعد ولا جدران”.
أما الزقاق الذي يقع فيه “كشك الثقافة” الآن، مستريحا باتكائه على مبنى البنك العربي، فقد كان موقفا لسيارات السرفيس التي تنطلق من عمّان إلى مدن فلسطين؛ القدس ورام الله وأريحا ونابلس، كما أن محل حبيبة للكنافة النابلسية، قائم في مكانه حتى هذه اللحظة منذ عام 1953.
سألني أبوعلي عندما وصلت إليه؛ متى رأيتني أول مرة؟ قلت له أيمكن أن تذكرني لو قلت لك؟ قال يمكن. أنا يا سيدي ذاك الفتى الذي تسرب إليك من ورشة بناء ذات صيف من مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وكنت أحمل في جيبي حصيلة جهد وتعب كبيرين عانيت منهما طوال تلك العطلة الصيفية في أعمال البناء. جئتك حاملا دنانيري القليلة، وقلت لك، حينها، أُريد مؤلفات ماركس ولينين وتشيخوف وغوركي وتلستوي ونجيب محفوظ وحنا مينا، فأنا أريد تأسيس مكتبتي.
لن أنسى ابتسامتك الحيادية، كأنك أشفقت على ذلك الفتى الذي أخذت منه أشعة الشمس مأخذا من عناء ما، أو من حماسته المفرطة، كأنك كنت ترغب في أن تثنيني، أو أن تحد من اندفاعتي إلى طريق من الواضح أنني عزمت أمري على المضي فيه قدما.
أو كأن الطبيعة كانت ضد تحرشي بطريق الكتب السريعة بين القاهرة وبيروت وبغداد، فسخّرتك لتنفيذ هذه المهمة، يا الله لو تستطيع أن تتذكر يا أبوعلي أي شعور كانت تخفيه طيات ملامحك الحيادية تلك، فقد تعذر عليّ تفسيرها.
هل فعلا كنت لا تريد لذلك النهر الجارف النابع من تأليف الكتاب في القاهرة مارا ببيروت للطباعة والمستقر في بغداد للقراءة، أن تتسرب منه ولو قناة صغيرة لتتعرج في بادية الشام الجنوبية؟ إن كان الأمر كذلك، فلم بقيت متمترسا في هذه الزاوية لتعرض هذه الكتب على مر هذه السنين كلها؟
أصارحك الآن، وبعد فوات تلك العقود، أنني لم أفهم إلا متأخرا أنك أشفقت علي من تبعات أدركت الآن كم هي مرهقة.
أريد هذه الكتب يا أبوعلي، فأدرت ظهرك، مستسلما لرغبتي، إلى الرفوف ورحت تختار بأناة وبعد تفكير طويل أمام كل كتاب، وأخذت تستشيرني، بين فينة وأخرى، بأسماء وعناوين الكتب، بلهجة يتخللها الترغيب والترهيب في إطار من التوجيه والإرشاد، هذا الكتاب سهل أما هذا فصعب عليك، خذ هذه الرواية فهي جميلة.
لقد تحايلت على حماسة ابن السادسة عشرة، وصعّبت ما كنت عازما عليه، وأقنعتني بما تريد، لم تكن ورّاقا فقط، نعم كنت مرشِدا ومرشّدا لانفعالي، من دون تثبيط لهمتي، بالقليل من التوجيه، كي لا أمل، أنا الآن أتفهم ما كنت ترمي إليه، فأنت أعرف الناس بأولئك المتحمسين لشراء الكتب الكثيرة، الذين سرعان ما يملّون، ولا يقرأون كل ما يشترون.
أجيال الكتاب والقراء
أبوعلي رجل صموت، في الأغلب، ربما لكثرة ما مرّ ويمر عليه، أو ربما هو يشعر الآن بآلام فراق كثيرة وكبيرة ألمّت به، فهو رجل عاشر بطيب الراحلين عبدالمنعم الرفاعي ومنيف الرزاز وتيسير سبول ومحمد طملية ومؤنس الرزاز وأحمد فؤاد نجم وجورج حبش وغيرهم. نعم؛ فقد مرّوا جميعا من هنا وتوقفوا أمام الكشك وجادله كل واحد منهم حول كتاب ما، هل تفتقدهم يا أبوعلي؟ من أعزّهم إلى قلبك؟
كخجول يربأ بنفسه أن يتورط في لعبة المفاضلة بين أصدقاء أمعنوا في الغياب، فلا يظهر عواطفه أو انحيازاته، فقط يختصر فضح مشاعره بالقول: كلهم.
لكن هذا الصموت سرعان ما يتوقف عن صمته، بمجرد أن تفتح معه حديث الذكريات، لا عليك، فقط افتح له شباكا على الماضي وخذ من القصص إثارة وعبقا، خذ ما لا ينتهي من تدفق، لكن ثمة من ابتدع طريقا آخر لانطاقه، فهذا مؤنس يأخذه معه إلى عوالمه البديعة، يأخذه معه في رواية “سلطان النوم وزرقاء اليمامة، ألف رواية ورواية في حكاية”، فيدخله في حوار مطول مع زرقاء اليمامة، فها هو أبوعلي “يرحب بها ويعبر عن شوقه وشوق الناس إليها، وحدثته هي عما رأته قبل قليل، ضرب كفا على كف، وقال: العالم فقد عقله”.
في ولوجه الصمت يدّخر طاقاته للانفجار مرة واحدة، يجمع كل حججه ليدافع عن كتبه، فهو شخص لا يتورع عن الانحياز للكتاب، فما إن يسأله أحد العابرين حتى يبدأ بشرح مركّز، يعرف ما يقول للباحث عن كتاب، ودائما لديه بدائل يقدمها على استحياء، غير أنه لا يتردد في إبداء رأيه في الكاتب والكتاب.
يقسّم أبوعلي زبائنه إلى أجيال، حسب ما مرّت به المنطقة من أحداث وصروف، فقد بدأ عمله في بيع الجرائد والكتب والمجلات، هنا في وسط البلد، حيث كان يقف على ناصية الشارع إلى جانب سوق الذهب، وكانت للصحف في الخمسينات من القرن الماضي أهمية كبرى لدى الساسة والمثقفين وسائر الفئات الاجتماعية، فمن خلالها كانوا يتابعون أخبار العالم المفصّلة، ويقرأون ما يكتب الصحافيون، يقول أبوعلي: إن الصحافة كانت النافذة التي يطلّون منها على العالم.
مثلا؛ وصفي التل، حيث كان في حينها مدير الإذاعة الأردنية الفتية، يأتي كل يوم ومعه صلاح أبوزيد ليتناولا طعام الغداء في مطعم جبري، وقبل ذلك، لا بد أن يمرّا بأبوعلي فيأخذ وصفي منه الصحف ويدعوه إلى طعام الغداء، وأبوعلي يقول إنه كان ينتظره أصلا ليرافقه إلى المطعم.
عندما سألته صحيفة “العرب” عن منيف الرزاز، قال: كان طبيبا وله عيادة في شارع بسمان وهو الشارع الموازي لشارع الملك فيصل، ويكمل حديثه، بأنه كان يأتي إليه في صباح كل يوم ليأخذ الجرائد، وفيما يذكر عن الرزاز، يقول: إنه كان يعالج الفقراء بالمجان.
موكب الرزاز
لا يخفي أبوعلي إعجابه بتلك الأجيال، فيواصل الحديث بحماسة منقطعة النظير عن منيف الرزاز ليكمل قصته بأن يقول “ابنه زارني البارحة”، فما يعنيه في الزيارة أن الذي جاءه ليس دولة رئيس الوزراء، عمر الرزاز بل ابن منيف، وعند سؤاله عن زيارة الرئيس وهل اشترى كتبا، قال أبوعلي: لا. وأضاف، كمن يختلق له الأعذار، كان معه حرس وموكب، أعتقد أنه سيعود خلال الأيام المقبلة من دون حرّاس أو مواكب وتصوير ليشتري بعض الكتب، ولا أدري لم ذكّرني هنا بأجواء جون شتاينبك في “شارع السردين المعلب”، ربما لعدم اكتراث أبطالها بموكب الرئيس.
تحدث مطولا عن تيسير سبول، فقد كان قبل السجن وبعده زبونا دائما عنده، وكذلك فايز محمود ومحمد طملية، وعن طبيعة العلاقة الخاصة التي كانت تربطه بكل واحد منهم، يقول إنهم كانوا يعودون إليه من المعتقلات ومن الأسفار ومن فصول ومقاعد الدراسة، فكل مساء كان هؤلاء ومعهم الكثير من الشباب يذرعون شوارع وسط المدينة جيئة وذهابا، يجلسون في المقاهي والمطاعم والحانات، يختلسون النظر إلى الفتيات، ويتوقفون أمام كشكه يتصفحون الكتب والمجلات والصحف، أحيانا يشترون بعض الكتب وأحيانا كثيرة لا يشترون.
وكان لدى أبوعلي دفتر دين كبير، لكل كاتب صفحة يسجل عليه فيها ديون الكشك، ولم تكن الديون تقتصر على أثمان الكتب، بل تشمل أيضا بنودا أخرى كثيرة، منها أقساط الجامعات لبعض المثقفين الطلاب الذين كانوا يلجأون إليه لدفع الرسوم الجامعية إلى حين ميسرة، ومن ضمن مدينيه المقيدة أسماؤهم في الدفتر كان يفرد عدة صفحات لسجناء الرأي في المحطة، تحت طائلة التصنيف كديون معدومة.
يقول أبوعلي: إن زبائنه اليوم هم من الشباب وكلهم منكبون على قراءة الروايات، ومن الكبار الذين تستهويهم كتب الفكر والسياسة، أما الصحف، فقد انخفضت مبيعاتها إلى أقل من الخمس، ولم يعد متابعوها يعدّون إلّا قليلا، ربما لأنهم يتابعونها فقط لمتابعة النعوات والإعلانات القضائية. علاوة على أن الرجل يظل طيلة الوقت يستنكر قرصنة الكتب من قبل بعض مواقع الإنترنت، ويقول إن جزءا كبيرا من القراء هجروا الكتب الورقية إلى القراءة عن طريق الإنترنت.
حارس التراث الثقافي
ينظر أبوعلي إلى العالم من عل؛ فهو المتربع فوق كل هذه الذكريات والإرث العظيم، مزهوا بكونه الحارس الأمين للمكان وذاكرته، المكان الذي مرّت عليه السنون والساسة والأيام، والتقى فيه كل يوم، على مدى السبعة عقود الماضية، كبار الساسة والمثقفين والكتاب، يعرفهم جميعا، خذ على سبيل المثال لا الحصر الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي، فقد كان زائرا يوميا للكشك يقضي ساعات طوالا عنده، ويقول أبوعلي إنه ظل طوال هذه الفترة الطويلة من العمل في الكتب على علاقة مع معظم الكتاب والمثقفين الأردنيين والفلسطينيين والعرب، فلا تكتمل زيارة أديب أو مثقف إلى الأردن إلا بزيارة كشك أبوعلي والتعرف إليه.
يمتلك أبوعلي من العناد ما يكفيه لأن يدعي وصلا، بدرجة عالية من الجدية، بمهمة جليلة، فهو يشعر أنه الحارس على التراث الأدبي والفكري، ولن يسمح بأن تتكرر المآسي القاسية في إبادة الكتب، مثل تلك التي حلّت بمكتبة طرابلس أو بغداد، إنه رجل من قلق، فما زالت تسكنه هواجس الاحتراس من هجمة المغول أو الحملة الصليبية بتخلق جديد، فلم يعد يهمه اليوم ربح أو خسارة، إنما الحفاظ على هذا الإرث العظيم لمهنته الممتد تأريخ نشأتها إلى القرن الرابع للهجرة.
كان من زبائن أبوعلي أيضا الشاعر الفلسطيني سميح القاسم والروائي الراحل عبدالرحمن منيف والمفكر البحريني محمد جابر الأنصاري والمئات من صانعي القرار الذين عرفتهم عمّان والعالم العربي. وليبقى أبوعلي ذلك الرجل الذي كتبت عنه الصحف العالمية العديد من المقالات، وورد اسمه في الروايات والقصائد وصار علامة فارقة من علامات الأردن.