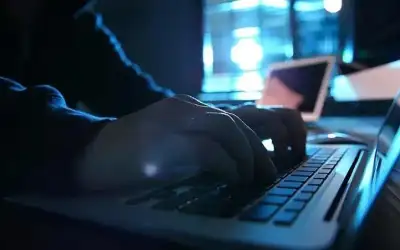عن الثلج وأمّي والزمان
محمد جميل خضر
قاص واعلامي اردني
نيسان ـ نشر في 2019-01-09 الساعة 16:31
نيسان ـ في عام 1982، وتحديداً مطلع شهر شباط (فبراير) منه، وبعد أن تعمقتْ مضاعفات مرض النكاف (أبو دغيم) الذي داهمني في عطلة نصف السنة (كنت بالتوجيهي)، أدخلني أهلي المستشفى العسكري في ماركا. كان أبي رحمه الله يعمل كوّى مدني في الشرطة العسكرية، وكنّا مؤمّنين في مستشفيات الجيش. بعد دخولي المستشفى بأيام، تحديداً يوم ثلاثاء (اليوم الأسبوعي لمنع الزيارات أيامها)، كنت مستلقٍ على سريري أقرأ في رواية حنا مينا "الثلج يأتي من النافذة" في حين كان الثلج الحقيقي وليس الروائي يطرق فعلاً شبابيك نافذة الغرفة، مستغرقاً في عوالم الرواية ومسكوناً بقلقٍ آسرٍ على مصير بطل الرواية اليساريّ المطارد من قبل أجهزة أمن بلده. لعل من أسباب استغراقي في الرواية إضافة لحجم التشويق فيها، يقيني أن أمّي لبيبة لن تزورني ذلك اليوم، فمن جهة لا زيارات يوم الثلاثاء، ومن جهة أخرى كان الثلج يتساقط ندفاً كبيرة في الخارج.
وفيما أنا منهمك أنتقل من صفحة إلى أخرى، ومشغول بتقبيل كل ندفة ثلج تنقر شباك غرفتي في المستشفى العسكري، وإذا بأمي تدخل حاملةً حقيبةً من البوص تحوي مختلف تفاصيل حبها وحرصها وحدبها. لم يمنعها الثلج ولا الأوامر العسكرية الصارمة.
لم يكن هذا الموقف هو الموقف اليتيم الذي يخبر الواحد منّا كم تختلف الأمهات عن سواهن وعن خلق الله أجمعين. لم يكن دليل حبها الوحيد. وإعلان براءة الأم من الحب المشروط أو العطاء المحدود أو الاختباء خلف الذرائع المقنعة: ثلج.. بعد مسافة.. منع زيارة وما إلى ذلك.
في ذلك الزمان البعيد، لم يكن يعرف الناس المواصلات كثيراً، كانوا في كثير من الأحيان يسعون في مناكبها مشياً على الأقدام. أنا مثلاً كنت أنزل سبعينيات القرن الماضي، يومياً لمكتبة الأطفال التابعة لأمانة عمّان نهاية شارع الهاشمي وسط البلد، مشياً وأعود منها مشياً، فحتماً ما كان يمكن أن أحصل على مصروف خاص غير مصروفي المدرسي لأطالع في المكتبة العامة، وأقرأ قصص سوبرمان ومغامرات تختخ ولوزة ونوسة ومن بعدهم الشياطين الـ13، لم يكن لا بواردي ولا بوارد أهلي فعل ذلك. وكي نكون أكثر دقة لم يكن بمقدورهم تحقيق هذا (الرفاه) لي.
عموماً، وبما يتعلق بلقمة العيش وما نضعه فوق أجسادنا ونستر به طفولتنا الحائرة بين جبل الحسين ومخيم الحسين، لم تكن تعدم أمّي الوسيلة. هي لمن لا يعرفها مقاتلة من طراز شرس. لبؤة بالمعنى الحرفي للكلمة. تغدو خماصاً وتؤوب سماناً. تحيك الوقت، تطرز الحكايات والأحلام والميجنا. تغني واقفة أمام المجلى: (هو صحيح الهوى غلّاب ما اعرفش أنا).
ذاتَ يومٍ (1969) دخلتُ روضةً (روضة المأمونية) ما يطلق عليها هذه الأيام (كي جي 2) لا أدري لماذا يذكّرني هذا الاسم المعاصر بالمخابرات السوفياتية (كي جي بي).. تصادف أن مقعدي كان بمحاذاة جدار الصف ونوافذه.. لون الستائر يميل إلى البنّي الفاتح جداً (البيج).. تلك الستائر تحولت في يومي الأول هناك إلى منديل أمسح به دمعتي.. سألتني المعلمة التي لا أتذكر رائحتها: ماذا بك (مالك)؟ فأجبتها من بين البكاء والحشرجة: أريد أمّي (بدي إمّي)... وحتى يومنا هذا ما أزال أريد أمّي مدفوعاً بحنينٍ جارفٍ إلى الرحم.
رحمك الله يا أمّي وأكرم مثواك، سيمضي وقتٌ طويلٌ وكئيبٌ وصادمُ قبل أن أستفيق من غيبوبة رحيلك.
وفيما أنا منهمك أنتقل من صفحة إلى أخرى، ومشغول بتقبيل كل ندفة ثلج تنقر شباك غرفتي في المستشفى العسكري، وإذا بأمي تدخل حاملةً حقيبةً من البوص تحوي مختلف تفاصيل حبها وحرصها وحدبها. لم يمنعها الثلج ولا الأوامر العسكرية الصارمة.
لم يكن هذا الموقف هو الموقف اليتيم الذي يخبر الواحد منّا كم تختلف الأمهات عن سواهن وعن خلق الله أجمعين. لم يكن دليل حبها الوحيد. وإعلان براءة الأم من الحب المشروط أو العطاء المحدود أو الاختباء خلف الذرائع المقنعة: ثلج.. بعد مسافة.. منع زيارة وما إلى ذلك.
في ذلك الزمان البعيد، لم يكن يعرف الناس المواصلات كثيراً، كانوا في كثير من الأحيان يسعون في مناكبها مشياً على الأقدام. أنا مثلاً كنت أنزل سبعينيات القرن الماضي، يومياً لمكتبة الأطفال التابعة لأمانة عمّان نهاية شارع الهاشمي وسط البلد، مشياً وأعود منها مشياً، فحتماً ما كان يمكن أن أحصل على مصروف خاص غير مصروفي المدرسي لأطالع في المكتبة العامة، وأقرأ قصص سوبرمان ومغامرات تختخ ولوزة ونوسة ومن بعدهم الشياطين الـ13، لم يكن لا بواردي ولا بوارد أهلي فعل ذلك. وكي نكون أكثر دقة لم يكن بمقدورهم تحقيق هذا (الرفاه) لي.
عموماً، وبما يتعلق بلقمة العيش وما نضعه فوق أجسادنا ونستر به طفولتنا الحائرة بين جبل الحسين ومخيم الحسين، لم تكن تعدم أمّي الوسيلة. هي لمن لا يعرفها مقاتلة من طراز شرس. لبؤة بالمعنى الحرفي للكلمة. تغدو خماصاً وتؤوب سماناً. تحيك الوقت، تطرز الحكايات والأحلام والميجنا. تغني واقفة أمام المجلى: (هو صحيح الهوى غلّاب ما اعرفش أنا).
ذاتَ يومٍ (1969) دخلتُ روضةً (روضة المأمونية) ما يطلق عليها هذه الأيام (كي جي 2) لا أدري لماذا يذكّرني هذا الاسم المعاصر بالمخابرات السوفياتية (كي جي بي).. تصادف أن مقعدي كان بمحاذاة جدار الصف ونوافذه.. لون الستائر يميل إلى البنّي الفاتح جداً (البيج).. تلك الستائر تحولت في يومي الأول هناك إلى منديل أمسح به دمعتي.. سألتني المعلمة التي لا أتذكر رائحتها: ماذا بك (مالك)؟ فأجبتها من بين البكاء والحشرجة: أريد أمّي (بدي إمّي)... وحتى يومنا هذا ما أزال أريد أمّي مدفوعاً بحنينٍ جارفٍ إلى الرحم.
رحمك الله يا أمّي وأكرم مثواك، سيمضي وقتٌ طويلٌ وكئيبٌ وصادمُ قبل أن أستفيق من غيبوبة رحيلك.
نيسان ـ نشر في 2019-01-09 الساعة 16:31
رأي: محمد جميل خضر قاص واعلامي اردني