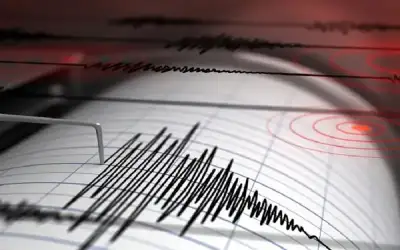عملية فيينا: مكافحة الإرهاب بموازاة الحل السياسي
راغدة درغام
كاتبة لبنانية
نيسان ـ نشر في 2015-11-12 الساعة 21:53
الزخم هو العنوان الذي وقع اختياره على اجتماعات فيينا الثانية لمعالجة المسألة السورية بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأكبر الدول الإقليمية وبقيادة روسية – أميركية يأمل وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وجون كيري بأن تقودهما إلى أوسلو ليتسلما جائزة نوبل للسلام في غضون 18 شهراً. هذا البرنامج الزمني اقترحته موسكو ليكون روزنامة إنجازات عسكرية تتمثل في سحق «داعش» و «جبهة النصرة» وتنظيمات أخرى تريد لها أن تُصنّف إرهابية، وروزنامة سياسية تتمثل في إصلاحات وتعديلات دستورية وإعادة صوغ نظام حكم في سورية تنتهي بانتخاب رئيس. إحدى الأفكار الخلاقة لرحيل الرئيس بشار الأسد هو إقناعه أو إجباره على عدم خوض المعركة الرئاسية، وهكذا يتم تفكيك عقدة الأسد. إنما العقَد لا تقتصر على الرجل، بل تشمل عقدتين ستتناولهما عملية فيينا هما: تصنيف مَن هو الإرهابي ومَن هو المعارض في الساحة السورية، أولاً. وثانياً، ما هو مصير القوات الأجنبية التي تحارب في سورية حالياً، وما هو التدريج الزمني لمغادرتها الأراضي السورية وتحت أية ظروف، والكلام ليس عن القوات الروسية وإنما هو عن القوى الإيرانية المتمثلة بوجود عسكري مباشر وبميليشيات منظمة مرجعيتها طهران. العقدة الأهم تكمن في المتطلبات الميدانية للأولوية القاطعة لكل من روسيا والولايات المتحدة وهي سحق «داعش» و «جبهة النصرة» و «القاعدة» ومشتقاتها، إذ إن موسكو لا تأبه بهوية من يتحالف معها في الحرب على هذه التنظيمات الإرهابية بينما واشنطن لا تريد أن تكون حليفاً مع «حزب الله» والميليشيات الأخرى التابعة لطهران، والتي تحارب في سورية دعماً لبشار الأسد ونظامه، والتي تصنّفها في خانة الإرهاب. العقدة، إذاً، إيرانية نوعاً ما، إنما نظراً إلى العلاقة التهادنية بين واشنطن وطهران، إنها قابلة للمعالجة وفق تفكير الثنائي لافروف – كيري ورغبته، لكنها موضع خلاف عميق مع القيادات العربية التي تحتاج إليها موسكو وواشنطن لإنجاح عملية فيينا وللانتصار في الحرب على الإرهاب في سورية.
إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء على أيدي إرهابيي «داعش» أو مشتقاته سيكون حاضراً في فيينا الثانية، وجولات أخرى تليها. فهذه حرب نصبت روسيا نفسها في الصفوف الأمامية ضدها، وإسقاط الطائرة الروسية نبّه الكرملين إلى خطورة تلك القيادة على روسيا. القاعدة الشعبية الروسية قد تقرر أن لا شأن للرئيس فلاديمير بوتين بتنصيب نفسه زعيم الحرب على الإرهاب الذي يأتي بالانتقام من سياساته على المصالح الروسية وربما لاحقاً في عقر الدار الروسية، فتعارض سياساته. وقد تقرر، بدلاً، أن منطق بوتين الذي يتبنى منطق الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في حربه على العراق صحيح وهو: نحاربهم هناك كي لا نحاربهم في المدن الروسية. إنما الآن، لا مناص من الإقرار بأن الانتقام من السياسة الروسية في سورية أتى سريعاً، وأن موسكو قد تختار التقدم بالتنازلات السياسية الضرورية لتوطيد مقومات إنجازاتها الميدانية في الحرب على الإرهاب.
منطقياً، هذا يعني أن «الجيش السوري الحر» وأمثاله من المعارضة السورية التي تمثّل القوى على الأرض أو ما يسمىboots on the ground تشكل حاجة روسية لا يمكن موسكو الاستغناء عنها. فالجيش النظامي غير قادر على أن يلعب الدور المطلوب بكامله. وبما أن لا خلاف، وفق ما بات واضحاً، على ترتيبات الحفاظ على ركائز نظام الدولة الذي يُصنَع شرط الاتفاق على حل عقدة رئيس النظام، فقد ترى موسكو أن عليها التعجيل بتفكيك عقدة الأسد في أسرع مما تصوّرت. فإذا اختارت العكس، قوّضت إمكاناتها.
موسكو لن تعترف بأية ترتيبات أو تفاهمات أو أفكار خلاقة تتعلق بمصير الأسد، لا في فيينا، ولا في سوتشي. وإذا كانت هناك تفاهمات خلاقة، من الضروري أن تستمر التصريحات التي تبيّن الخلاف للتغطية على سرية الاتفاق. الزيارات الخليجية الرفيعة المستوى إلى سوتشي وموسكو تفيد بأن خيط الثقة لم ينقطع، وأن العمل جارٍ على إصلاح العلاقة الروسية – الخليجية، بل على توطيدها على مختلف المستويات، وأن التدخل العسكري الروسي في سورية لم تجد فيه الدول الخليجية داعياً لتأجيل أو إلغاء زيارات آخرها زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وزيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل نهاية السنة.
استراتيجية الدول الخليجية للتواصل مع روسيا لم تأتِ من فراغ، وإنما نتيجة تآكل نسبي في العلاقة الأميركية – الخليجية التقليدية. العلاقة التحالفية بين موسكو وطهران، وبالذات في سورية، لم تشكل عائقاً أمام إقبال القيادات الخليجية على روسيا، على رغم تاريخ الاستياء الخليجي من السياسات الروسية والإيرانية الداعمة نظامَ الأسد على مدى خمس سنوات. لعل وراء هذا الإقبال نحو موسكو اقتناع بأنه سيسفر عن تباعد نسبي مع طهران. ولعل هناك اقتناعاً بأن لا مجال للاستقطاب، إنما لا داعي للعداء. ولعل واشنطن نفسها شجعت التقارب الخليجي – الروسي لأنه ضروري لتقاربها مع كل من روسيا وإيران معاً. ولعل الدول الخليجية أدركت أن أمامها إما خيار المقاطعة احتجاجاً على العلاقة الجديدة بين واشنطن وموسكو وطهران، أو خيار الموافقة على متطلبات الأمر الواقع الجديد فقررت الموافقة.
ما يحدث عملياً في فيينا هو تشكيل مجموعة دولية – إقليمية للبحث في المسألة السورية وصوغ الحلول لها. عندما تولى الأمين العام السابق كوفي أنان مهمة المبعوث الدولي لسورية، سعى وراء أرضية مشتركة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تلاه الأخضر الإبراهيمي الذي سعى وراء أرضية مشتركة أميركية – روسية كأساس ضروري لأي حل في سورية. كلاهما شجّع تكراراً على القبول بإيران على طاولة المفاوضات حول مستقبل سورية، وكان الرد السعودي أن ذلك مرفوض لأنه يمثل شرعنة للدور الإيراني في سورية. المبعوث الحالي، ستيفان دي ميستورا، ينظر إلى مهمته اليوم بأنها تسهيلية وليست قيادية ويقول: «وظيفتي هي التأكد من أن تجلس روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران إلى الطاولة لتأتي بالعملية السياسية، ثم نجمع النقاط ونمشي بها، أن نفرض نحن معادلة معينة للحل». وهذا هو الزخم الذي أنتجه اجتماع فيينا الأول، في نظره، والذي يجب البناء عليه بدعم من مجلس الأمن الدولي.
الصين التي تتبنى تقليدياً الجلوس في المقعد الخلفي لكل ما يتعلق بسورية في مجلس الأمن تاركة القيادة لروسيا، قرر فجأة سفيرها لدى الأمم المتحدة أن يظهر أمام الصحافة في إطلالة غير مسبوقة ليشدد على «ضرورة تآزر الجهد الدولي في محاربة الإرهاب» في سورية، وليرحب بانعقاد اجتماع فيينا مشدّداً على أن الصين «ستواصل دعم الاجتماع الوزاري الثنائي» بهدف الدفع قدماً إلى «حل من طريق المفاوضات». وفي الجلسة المغلقة، كان سفير الصين متحمساً لإبراز موقف بلاده ذي الأربع نقاط: الدفع نحو إطلاق النار، ما يساعد على تحسين الأوضاع الإنسانية. الالتزام بالحل السياسي من خلال عملية سورية. دعم دور الأمم المتحدة كقناة حوار ودورها في إجراء الانتخابات. توطيد التعاون الدولي وتعزيزه لمكافحة «داعش».
دي ميستورا أبلغ أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المغلقة بأن عملية فيينا تنطلق من نقطة مشتركة أساسية يوجد تفاهم حولها هي مكافحة الإرهاب كأولوية، مع تأكيد أن تلك المكافحة تكون فعّالة فقط إذا كانت هناك عملية سياسية موازية. قال أن المهام الرئيسية للأمم المتحدة وفق تصوّر فيينا هي المساعدة على وضع الدستور، المساعدة في الانتخابات، ووضع شروط وقف النار. وأوضح أن مجموعة الدعم الدولية ستسعى لتعالج الخلافات حول تصنيف الإرهاب وتحديد المعارضة السورية.
وأثناء لقائه الصحافة، رفض دي ميستورا إعلان موقفه حيال معايير تحديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، خصوصاً أن لإيران و «حزب الله» مقاتلين في سورية، معتبراً أن مهمته هي «تسهيل المفاوضات الجارية، لا قيادتها». وقال: «لن أحدد موقف الأمم المتحدة من هذه القضايا لأننا نحاول لأربع سنوات ولم ننجح، وحان الآن دور الدول لتتولى هذه التحديات».
هناك رأيان حول جلوس إيران إلى طاولة رسم المستقبل السوري: رأي يقول أن إيران ستكون مسؤولة أكثر، وأنها ستكون رهن المحاسبة أكثر لأنها لاعب واضح على الطاولة، والمطلوب منها الآن هو التقدم بأدلة على أنها تستخدم اتصالاتها وميليشياتها بصورة بنّاءة وفي إطار التفاهم العالمي على ضرورة سحق «داعش»، وضرورة الانتقال السياسي في سورية. الرأي الآخر يقول إن إجلاس إيران إلى الطاولة هو عبارة عن دعم الأمر الواقع للطروحات الروسية القائمة على أولوية سحق الإرهاب وهو تأهيل للميليشيات التابعة لطهران كطرف شرعي في هذه الحرب، وبالتالي إلغاء صفة الإرهاب عنها. وأصحاب هذا الرأي يريدون إيضاحات حول ما تريد إيران لنفسها في سورية الغد ومدى قبول الثنائي الأميركي – الروسي بالطموحات الإيرانية في سورية.
ليست هناك رائحة اتفاق في فيينا على تقسيم سورية، بل هناك إصرار علني على وحدة أراضيها. لا دخان من فيينا بأن العلاقة السعودية – الإيرانية على وشك الانفجار، وإلا لما عاد الوزيران إلى طاولة المفاوضات. نكهة المقايضات تفيد بأن الولايات المتحدة وروسيا تصران على لجم شهية إيران في اليمن. إنما لا مؤشر إلى استعداد أي كان لاستخدام أدوات الضغط على طهران، حالياً، على نسق تحدي شرعية وجودها عسكرياً في سورية بانتهاك لقرار صادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق.
الحياة