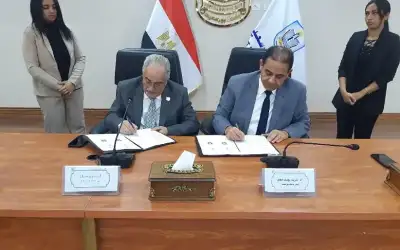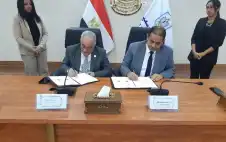التعويذة
نيسان ـ القدس العربي ـ نشر في 2025-03-28
نيسان ـ د. ابتهال الخطيب
نحن في دولنا العربية مهمومون مغمورون بفكرة رابط الدم والأصالة ووحدة العِرق، التي كلها مفاهيم سلبية علمياً من حيث إيقاعها بكثير من الأمراض الجسدية والنفسية في حال تحققها المتوالي والمتلازم للمجموعة المعنية، حتى إننا نقدم رابط الدم هذا «بأصالته ونقاء عرقه» على كل ما عداه ولو كان أهم ثروة يمكن أن تتكون على سطح الأرض، وهي الثروة البشرية. نحن نفضل المجموعة الصغيرة المتوحدة عرقياً على المجموعة الكبيرة المتنوعة، نُعلي رابط الدم على رابط الفكر، نفخر بالأصالة ولا نفاخر بالإنجاز، لذا تجدنا دوماً نفضل أن ننكفئ على أنفسنا، مفاخرين بأصولنا الواحدة وديننا الواحد ولغتنا الواحدة، غير واعين أن هذا «توحد» خطير، توحد يمنع عنا الاختلاط الصحي بالآخر والتفاعل الطبيعي معه، الذي يوسع مداركنا ويثري ثقافتنا ويلين قلوبنا وعقولنا مفسحاً مكاناً كبيراً للتسامح وقبول الآخر.
ومرض التوحد الجيني هو مرض ذو أعراض انعزالية، وله دلالات سلوكية تظهر على الإنسان منذ عمر صغير، إلا أن له جوانب إيجابية عدة، منها ارتفاع نسب الذكاء عند أصحاب هذا الاضطراب الذي يحولهم انعزالهم أحياناً إلى نوابغ مميزين جداً. أما مرض التوحد الاجتماعي، الذي هو آفة مجتمعاتنا العربية تحديداً وإن عانت منه كل البشرية على مر الأزمان، فأعراضه ودلالاته غاية في الخطورة. وأما نتائجه التي أهمها انخفاض نسب الذكاء وارتفاع نسب التفاهة والغباء، فقد تكون مميتة. الانعزال المجتمعي والانطواء على مجموعة واحدة متشابهة متحدة الأصول (ولو أن هذا الاتحاد بحد ذاته أكذوبة بشرية كبيرة) موحدة اللغة ومتجانسة الدين والفكر، يجعل الإشارات العصبية السارية في مخ هذا المتوحد اجتماعياً المنعزل عن «الآخر» فاسدة فساد كريات الدم السارية في شرايين هذا «النقي» عرقياً، والذي بقيت عائلته أو قبيلته تتناسب وتتزاوج داخلياً محافظة على أصالة الدم حتى وصلوا إليه بشتى الأمراض البدينة والعقلية المختلفة. فلأي سبب ما زلنا نسعى لغلق أبوابنا علينا؟
وعليه، نتساءل من منطلق مدني عملي بحت: هل تتضرر البلدان من زوارها ومقيميها ووافديها؟ هل تتأثر بضمها للآخرين لمجتمعها وثقافتها عبر التجنيس والتوطين والقبول والاحتواء؟ لنا في المجتمعات الأوروبية خير مثال، ففي هذه المجتمعات نظام سياسي واجتماعي ضخم معني بضم «الآخر» للمجتمع وإعادة تأهيله، بل واجتذابه وتحبيبه في مجتمعه الجديد، وذلك عبر تقديم الخدمات له واحتوائه وإشعاره أنه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وكذلك عبر فرض واجبات اجتماعية عليه عبر فرض تعلّم اللغة والتاريخ للمجتمع المعني لضمان فهم أعمق للمنضم الجديد لهذا المجتمع بكل تاريخه وظروفه، ولغرس ماض جديد للمنضم الجديد، ماض يجاور الماضي القديم ويعوض عن فقد مصدره. فعندما تصبح الأرض الجديدة عوضاً طيباً عن الأرض القديمة، التي لا بد أن ظروف توديعها كانت قاسية وقهرية، يصبح هذا الإنسان راضياً نفسياً، ثم فاعلاً مواطنياً، وهو ما مكسباً لمجتمعه الجديد.
كلمة مكسب هي مربط الفرس، ففي حين أن مجتمعاتنا تنظر «للآخر» على أنه عالة وعبء على المجتمع وفم آخر للإطعام، تنظر له المجتمعات الغربية على أنه asset أو مكسب أو مربح، وأنه يد عاملة إضافية وعقل إضافي، ذلك أنها مجتمعات تفهم أنه لا يوجد أغلى أو أثمن من الإنسان، هو الثروة الحقيقية الفاعلة التي تحرك وتغير وتؤثر في كل ما حولها. صحيح أن وضع اللجوء أصبح عسيراً جداً مؤخراً خصوصاً بعد فترة النزوح السوري إلى أوروبا الذي ترك أوروبا متوترة بسبب الأعداد غير المسبوقة نزوحاً، وإن اكتشفت هذه المجتمعات لاحقاً أن المهاجر السوري هو ثروة عاملة حقيقية، وصحيح أن حرب الإبادة على غزة عرت الغرب من معظم مثالياته، لكن تقييم الإنسان كمكسب أو مادة ربحية مفهوم لا يزال قائماً وبقوة عند الغرب، انطلاقاً من دوافع مصلحية في الواقع، لا إنسانية. فاليد العاملة والعقل الإضافي يعنيان محركاً أقوى وأضخم للدولة، ويعنيان ضرائب إضافية وحراك سوق إضافية ولو في أصغر صوره، ويعنيان أيضاً تنوعاً صحياً وثقافة إضافية وفكراً متجدداً، وكيف يمكن للغرب أن يصنع حضارته التكنولوجية والرقمية الأسطورية المرعبة اليوم بلا هذا التجديد وبمعزل من ثقافات العالم المختلفة؟ كيف ولمن سيبيع الغرب بضاعته الخارقة إن لم يفهم ويحتوي الثقافات الأخرى؟
الغرب يتقدم رغم سقوط قناع الإنسانية عنه، والشرق الأوسط يتأخر رغم أنه صاحب القضية الإنسانية الأولى في العالم، ذلك أننا لم نعرف قط كيف نوظف الإنسان ونؤهله ونحتويه ونكسبه بعيداً عن المفاهيم العشائرية القديمة للعرق وامتداد الدم. لو كانت دولنا مرحبة «بالغرباء» لكان المزيد من البشر يقطنون بيننا ولكانوا أصواتاً إضافية تساندنا في قضيتنا الفلسطينية العادلة. لو كانت دولنا محتوية لوافديها لكانوا قوة يد وعقل إضافية تدفع بتروس محرك الدولة، وبكل جسمها التطوري. لو كانت دولنا محبة «عِشرية» مع ضيوفها ميسِّرة لتجنيسهم وضمهم إلى صفوف مواطنيها لكانت مجتمعاتها أقل عنصرية، وأكثر قبولاً للآخر، وأقل طائفية، وأكثر فهماً للمختلف، أقل خوفاً ورضوخاً، أعلى صوتاً سياسياً، أقل فساداً وأكثر شفافية، ذلك أن الثقافات الأخرى كانت لتجلب معها تنوعاً كبيراً ومفاهيم مغايرة عن تلك التي نعرف للطاعة والانقياد و»الهون الذي هو أبرك ما يكون».
أن يكون كل الأشخاص ذوي سحنة متشابهة، ملبس متشابه، سلوك متطابق، يسيرون على الإيقاع نفسه، ويفكرون بنفس الاتجاه، ويشعرون بذات الأحاسيس، إنما هذا يبدو مشهداً من فيلم رعب تقع شخصياته تحت سيطرة تعويذة تسيّرهم وتتحكم فيهم، إلى أن يأتي بطل ما فيرفع هذه التعويذة. إلى متى نبقى بانتظار المخلّص؟
نحن في دولنا العربية مهمومون مغمورون بفكرة رابط الدم والأصالة ووحدة العِرق، التي كلها مفاهيم سلبية علمياً من حيث إيقاعها بكثير من الأمراض الجسدية والنفسية في حال تحققها المتوالي والمتلازم للمجموعة المعنية، حتى إننا نقدم رابط الدم هذا «بأصالته ونقاء عرقه» على كل ما عداه ولو كان أهم ثروة يمكن أن تتكون على سطح الأرض، وهي الثروة البشرية. نحن نفضل المجموعة الصغيرة المتوحدة عرقياً على المجموعة الكبيرة المتنوعة، نُعلي رابط الدم على رابط الفكر، نفخر بالأصالة ولا نفاخر بالإنجاز، لذا تجدنا دوماً نفضل أن ننكفئ على أنفسنا، مفاخرين بأصولنا الواحدة وديننا الواحد ولغتنا الواحدة، غير واعين أن هذا «توحد» خطير، توحد يمنع عنا الاختلاط الصحي بالآخر والتفاعل الطبيعي معه، الذي يوسع مداركنا ويثري ثقافتنا ويلين قلوبنا وعقولنا مفسحاً مكاناً كبيراً للتسامح وقبول الآخر.
ومرض التوحد الجيني هو مرض ذو أعراض انعزالية، وله دلالات سلوكية تظهر على الإنسان منذ عمر صغير، إلا أن له جوانب إيجابية عدة، منها ارتفاع نسب الذكاء عند أصحاب هذا الاضطراب الذي يحولهم انعزالهم أحياناً إلى نوابغ مميزين جداً. أما مرض التوحد الاجتماعي، الذي هو آفة مجتمعاتنا العربية تحديداً وإن عانت منه كل البشرية على مر الأزمان، فأعراضه ودلالاته غاية في الخطورة. وأما نتائجه التي أهمها انخفاض نسب الذكاء وارتفاع نسب التفاهة والغباء، فقد تكون مميتة. الانعزال المجتمعي والانطواء على مجموعة واحدة متشابهة متحدة الأصول (ولو أن هذا الاتحاد بحد ذاته أكذوبة بشرية كبيرة) موحدة اللغة ومتجانسة الدين والفكر، يجعل الإشارات العصبية السارية في مخ هذا المتوحد اجتماعياً المنعزل عن «الآخر» فاسدة فساد كريات الدم السارية في شرايين هذا «النقي» عرقياً، والذي بقيت عائلته أو قبيلته تتناسب وتتزاوج داخلياً محافظة على أصالة الدم حتى وصلوا إليه بشتى الأمراض البدينة والعقلية المختلفة. فلأي سبب ما زلنا نسعى لغلق أبوابنا علينا؟
وعليه، نتساءل من منطلق مدني عملي بحت: هل تتضرر البلدان من زوارها ومقيميها ووافديها؟ هل تتأثر بضمها للآخرين لمجتمعها وثقافتها عبر التجنيس والتوطين والقبول والاحتواء؟ لنا في المجتمعات الأوروبية خير مثال، ففي هذه المجتمعات نظام سياسي واجتماعي ضخم معني بضم «الآخر» للمجتمع وإعادة تأهيله، بل واجتذابه وتحبيبه في مجتمعه الجديد، وذلك عبر تقديم الخدمات له واحتوائه وإشعاره أنه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وكذلك عبر فرض واجبات اجتماعية عليه عبر فرض تعلّم اللغة والتاريخ للمجتمع المعني لضمان فهم أعمق للمنضم الجديد لهذا المجتمع بكل تاريخه وظروفه، ولغرس ماض جديد للمنضم الجديد، ماض يجاور الماضي القديم ويعوض عن فقد مصدره. فعندما تصبح الأرض الجديدة عوضاً طيباً عن الأرض القديمة، التي لا بد أن ظروف توديعها كانت قاسية وقهرية، يصبح هذا الإنسان راضياً نفسياً، ثم فاعلاً مواطنياً، وهو ما مكسباً لمجتمعه الجديد.
كلمة مكسب هي مربط الفرس، ففي حين أن مجتمعاتنا تنظر «للآخر» على أنه عالة وعبء على المجتمع وفم آخر للإطعام، تنظر له المجتمعات الغربية على أنه asset أو مكسب أو مربح، وأنه يد عاملة إضافية وعقل إضافي، ذلك أنها مجتمعات تفهم أنه لا يوجد أغلى أو أثمن من الإنسان، هو الثروة الحقيقية الفاعلة التي تحرك وتغير وتؤثر في كل ما حولها. صحيح أن وضع اللجوء أصبح عسيراً جداً مؤخراً خصوصاً بعد فترة النزوح السوري إلى أوروبا الذي ترك أوروبا متوترة بسبب الأعداد غير المسبوقة نزوحاً، وإن اكتشفت هذه المجتمعات لاحقاً أن المهاجر السوري هو ثروة عاملة حقيقية، وصحيح أن حرب الإبادة على غزة عرت الغرب من معظم مثالياته، لكن تقييم الإنسان كمكسب أو مادة ربحية مفهوم لا يزال قائماً وبقوة عند الغرب، انطلاقاً من دوافع مصلحية في الواقع، لا إنسانية. فاليد العاملة والعقل الإضافي يعنيان محركاً أقوى وأضخم للدولة، ويعنيان ضرائب إضافية وحراك سوق إضافية ولو في أصغر صوره، ويعنيان أيضاً تنوعاً صحياً وثقافة إضافية وفكراً متجدداً، وكيف يمكن للغرب أن يصنع حضارته التكنولوجية والرقمية الأسطورية المرعبة اليوم بلا هذا التجديد وبمعزل من ثقافات العالم المختلفة؟ كيف ولمن سيبيع الغرب بضاعته الخارقة إن لم يفهم ويحتوي الثقافات الأخرى؟
الغرب يتقدم رغم سقوط قناع الإنسانية عنه، والشرق الأوسط يتأخر رغم أنه صاحب القضية الإنسانية الأولى في العالم، ذلك أننا لم نعرف قط كيف نوظف الإنسان ونؤهله ونحتويه ونكسبه بعيداً عن المفاهيم العشائرية القديمة للعرق وامتداد الدم. لو كانت دولنا مرحبة «بالغرباء» لكان المزيد من البشر يقطنون بيننا ولكانوا أصواتاً إضافية تساندنا في قضيتنا الفلسطينية العادلة. لو كانت دولنا محتوية لوافديها لكانوا قوة يد وعقل إضافية تدفع بتروس محرك الدولة، وبكل جسمها التطوري. لو كانت دولنا محبة «عِشرية» مع ضيوفها ميسِّرة لتجنيسهم وضمهم إلى صفوف مواطنيها لكانت مجتمعاتها أقل عنصرية، وأكثر قبولاً للآخر، وأقل طائفية، وأكثر فهماً للمختلف، أقل خوفاً ورضوخاً، أعلى صوتاً سياسياً، أقل فساداً وأكثر شفافية، ذلك أن الثقافات الأخرى كانت لتجلب معها تنوعاً كبيراً ومفاهيم مغايرة عن تلك التي نعرف للطاعة والانقياد و»الهون الذي هو أبرك ما يكون».
أن يكون كل الأشخاص ذوي سحنة متشابهة، ملبس متشابه، سلوك متطابق، يسيرون على الإيقاع نفسه، ويفكرون بنفس الاتجاه، ويشعرون بذات الأحاسيس، إنما هذا يبدو مشهداً من فيلم رعب تقع شخصياته تحت سيطرة تعويذة تسيّرهم وتتحكم فيهم، إلى أن يأتي بطل ما فيرفع هذه التعويذة. إلى متى نبقى بانتظار المخلّص؟